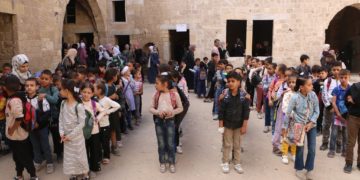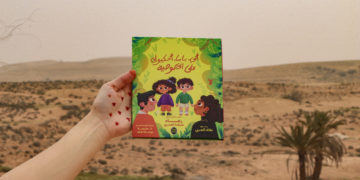هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)
وأنا جالسة أكتب هذا المقال، لم أجد ما أقوله أو أسترسل بكتابته. لم أكن يوماً من مؤيدي فكرة تخصيص أيام عالمية والاحتفال بها. لا يسعني إلا أن أنظر بشيء من الامتعاض إلى معظم المقالات والمنشورات التي تنبت كالفطر في هذا اليوم من كل سنة. والسبب أن الأمر يقف هنا ولا يتخطّى كونه مجرد منشور أو هاشتاغ. على الفور ننتقل جميعنا، نحن أجيال الإنترنت، إلى منشور جديد عن حديث (ربع) الساعة التالي. وخيبة الأمل بمواقع التواصل الاجتماعي ليست البتة انعكاساً لأي خيبة أمل شخصية بقناعاتي الخاصة أو تخلّياً عنها، إلا أنني أكاد أفقد الأمل تماماً بما يُسمّى الروح الجماعية وبأي عمل يعجز عن تجاوز أنانية الفرد وسعيه الدائم نحو تلميع صورته الشخصية من دون سواها.
يقلقني أن نشهد لحظة بلحظة كيف تؤثر أدائية وسائل التواصل الاجتماعي على واقعنا، فتُترجم في أنماط سلوكنا وتصرفاتنا المتكررة وكذلك في ما نكتبه وننشره. وبطبيعة الحال تسلك هذه الأدائية طريقها إلى آراء الآخرين وتساهم بشكل أساسي في تكوينها من عدمه. هذا لأننا لا نعيش في فراغ أو في عزلة عن العالم. فالناس يتأثرون بما يقرأونه وما يشاهدونه، أي أن عالم الإنترنت الافتراضي يُغذي العالم الواقعي. وإذا بنا نجر وراءنا الأدائية المسيطرة على وسائل التواصل ونسمح لها بالتسلل إلى تصرفاتنا اليومية. عنذئذٍ يتحول الناس إلى ممثلين وممثلات، وكل ما يفعلونه يصب في تعزيز الصورة التي اختاروها لأنفسهم على الإنترنت وعدم الحيد عنها قيد أنملة. مع استفحال النزعات الفردية مقابل الروح الجماعية، ليس من الخطأ أن نعتبر هذه الأدائية المفرطة سببًا في فشل اتحادنا معًا وتنظيم جهودنا.
يتحول الناس إلى ممثلين، وكل ما يفعلونه يصب في تعزيز الصورة التي اختاروها لأنفسهم على الإنترنت وعدم الحيد عنها قيد أنملة
نصادف ذلك كل يوم في عالمنا المنقسم إلى أقطاب ومحاور، حيث تتحكم بنا "الخوارزمية" وتعزز تمسكنا بقناعاتنا مهما كانت خطيرة. يتجلى ذلك من خلال الغضب الذي ينتابنا جميعاً بشكل آلي عندما يتم وصفنا بغير المتحضّرين، فنهبّ تلقائياً لإثبات العكس وإظهار وجهنا الحضاري للجهة التي أدانتنا. هذا ما يزعجني أيضاً بشأن اليوم العالمي للنساء: محاولاتنا الدؤوبة لنثبت أن النساء لسن أقل قيمة من الرجال. ومن أجل ذلك، ننهال على الآخرين بوابل من المنشورات إلى أن نقنعهم. الأمر يشبه تماماً إصرارنا على أن نبرهن للمعتدين أننا لسنا أقل شأنًا منهم. التشابه واضح وضوح الشمس.
سؤالي الأساسي هو لماذا؟ لمَ قد يرغب أحد أو يسعى إلى استجداء تأييد أو استحسان من الجهة التي تدينه، أو من أي جهة أخرى حتى؟ أليس من العبث أن نمنح شخصاً، بإرادتنا أو ربما من دون إدراك، صلاحية أن يحدّد لنا مدى إنسانيتنا؟
المضحك في الأمر أننا لن نفوز أبداً. أيقنتُ ذلك بناءً على تجربتي الخاصة، سواءً الآن أو في سن أصغر، إذ لطالما اتهموني بأني نسوية أكثر من اللازم (وكأنها صفة سيئة) وجعلوني أشعر بأني مُفسدة للمتعة، هم الذين يدّعون أنهم أكبر حلفاء للقضية النسوية. لا أقصد بكلامي أنه ينبغي ألا نتحدث عن الموضوع أو نزيد الوعي بأشكال عدم المساواة المتفشية في العالم. ولكنني أتساءل عند أي حد يجب أن نقف؟ متى نتوقف عن بذل المزيد من الجهد لإسماع صوتنا؟ متى يصبح على عاتق الآخرين البحث والتفكير وإدراك حقيقة الواقع الذي نعيشه؟ لمَ تكتفي الغالبية العظمى من الناس بالنظر إلى الأمور بسطحية بدلاً من التعمّق ولو قليلاً في ما يقرأونه ويشاهدونه؟ متى يبدأون بالتفكير جدياً في جميع جوانب المسألة؟
على أي حال، أظن أن أنجيلا ديفيس هي من كتبت عن مخاض ولادة الوعي السياسي. صحيح أنها كانت تتطرق إلى سياق تاريخي مختلف عما نعيشه اليوم، ولكن يبدو أن المزيد من الناس، الذين كانوا يجلسون بمنتهى الراحة على كرسيهم العالي المحصّن بامتيازاتهم الذكورية والعرقية والاجتماعية، باتوا الآن يعيشون آلام هذا المخاض ويتقبّلون على مضض وبكثير من الألم آثاره الجانبية، مدركين الأساسات التي شيّدت عليها امتيازاتهم.
ولكن، كيف لنا أن نحوّل التفكير الفردي إلى عمل جماعي مؤثر؟ بدأنا نسأم من تلك المعضلة، حتى أننا صرنا نجتر الحجج ونكرّرها. لست واثقة بأني أملك الإجابة، بل كل ما لدي هو المزيد من الأسئلة، على أمل أن نجيب عنها معاً.